جسدك ملكك أم أمانة من الله؟.. التبرع بالأعضاء يشعل الخلاف بين الفقه والطب
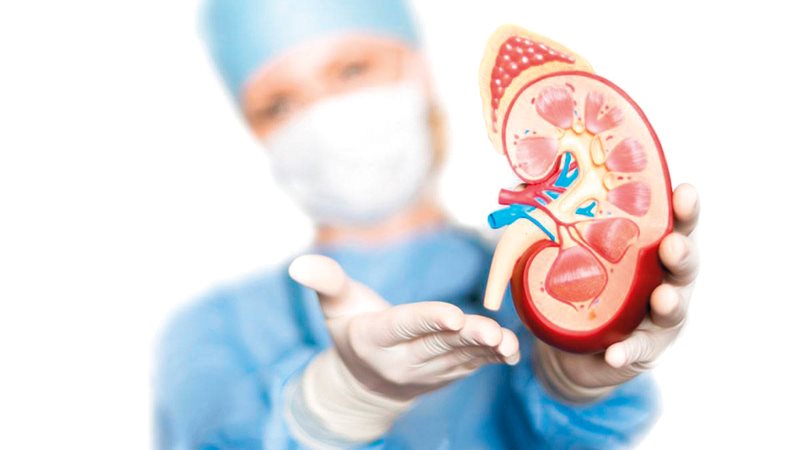
في زمنٍ تتسارع فيه الاكتشافات الطبية وتتعقد فيه القضايا الأخلاقية، يقف الإنسان أمام أسئلةٍ مصيرية تمسّ معنى الحياة والموت ذاته من بين تلك الأسئلة يبرز سؤالٌ يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الفقهية والطبية: هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت أو في حال الحياة؟
بين من يراه عملًا إنسانيًا يُثاب عليه صاحبه، ومن يراه انتهاكًا لحرمة الجسد الذي كرّمه الله، تتعدد الآراء والاجتهادات في محاولة الموازنة بين حفظ النفس أحد مقاصد الشريعة الكبرى وحرمة التصرّف في الجسد الذي أودعه الله أمانة عند الإنسان.
نسلط الضوء على الجدل الفقهي حول التبرع بالأعضاءومواقف المذاهب الإسلامية المختلفة، وقرارات المجامع الفقهية، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يستند إليها كل فريق، في محاولة لبلورة رؤية شرعية واضحة تنسجم مع روح الإسلام ومقاصده العليا.
الجسد في ميزان الشريعة.. أمانة لا مِلك للإنسان
ينطلق الفقهاء في بحثهم لهذه المسألة من أصلٍ شرعي مهم، وهو أن جسد الإنسان ليس مِلكًا مطلقًا له، بل هو أمانة من الله تعالى، قال سبحانه:
«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (الإسراء: 70).
فهذا التكريم يقتضي صيانة الجسد في الحياة والممات، وعدم العبث به بأي شكلٍ من الأشكال. لذلك يرى بعض العلماء أن الإنسان لا يملك أن يتصرّف في بدنه تصرّف المالك في مملوكه، لأن الملكية الحقيقية لله وحده.
ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى قول النبي ﷺ:
«كسر عظم الميت ككسره حيًا» (رواه أبو داود).
ويفهم من هذا الحديث أن حرمة جسد الإنسان بعد موته كحرمته في حياته، فلا يجوز التعدي عليه بالتمثيل أو الإتلاف أو الاستقطاع، ولو كان ذلك بنية نفع الغير.
لكن في المقابل، يرى آخرون أن حفظ النفس مقصد شرعي عظيم، وأن الله سبحانه قال:
«وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة: 32).
وهنا تبدأ الموازنة بين حرمة الجسد وواجب إنقاذ الحياة، وهي المعضلة التي شكّلت محور الخلاف الفقهي في هذه القضية المعاصره
بين التحريم والإباحة.. آراء المذاهب الفقهية في التبرع بالأعضاء
1. المذهب الحنفي: التحريم هو الأصل
يرى كثير من فقهاء الحنفية أن الإنسان لا يملك جسده ملكًا تامًّا يبيح له التصرّف فيه، لذلك حرّموا بيع الأعضاء أو التبرع بها، استنادًا إلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، ولأن الجسد محترم في الحياة وبعد الممات، ولا يجوز أن يُتخذ وسيلة مادية للمنفعة.
ويقولون إنّ التبرع بعد الموت يعدّ تعديًا على حرمة الميت، إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقرّرها وليّ الأمر أو العلماء المختصون، شريطة أن يكون الهدف هو إنقاذ حياة إنسان مؤكد الهلاك.
2. المذهب المالكي: جواز مشروط بالضرورة
أما المالكية فاقتربوا من موقف أكثر وسطية، فذهب بعض علمائهم المعاصرين إلى جواز نقل العضو من حيٍّ إلى حيٍّ آخر بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضررٍ محقق بالمتبرع، وأن يكون المقصد إنقاذ النفس لا مجرد تحسين الحياة.
وفي حالة الموت، أجازوا نقل الأعضاء بوصيةٍ سابقة من المتوفى أو بموافقة ورثته، بشرط حفظ كرامة الميت وعدم امتهان جسده، مستندين إلى مقاصد الشريعة في حفظ النفس ورفع الحرج.
3. المذهب الشافعي: بين المنع والتقييد
أما الشافعية، فاشترطوا لجواز التبرع أن يكون العضو المنقول قابلًا للنمو أو البقاء، وأن لا يؤدي النقل إلى هلاك المتبرع، كما اشترطوا تحقيق المصلحة الراجحة للمنقول إليه.
ويرى عدد من فقهاء الشافعية المعاصرين أن النقل بعد الوفاة يجوز إذا تحقق الموت اليقيني، وثبت أن العضو سينقذ حياة إنسان، مستشهدين بحديث النبي ﷺ:
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» (رواه البخاري ومسلم).
4. المذهب الحنبلي: الضرورات تبيح المحظورات
أما الحنابلة، فقد أباحوا التبرع بالأعضاء في حالات الضرورة فقط، انطلاقًا من القاعدة الفقهية: «الضرورات تبيح المحظورات».
لكنهم شدّدوا على أن الضرورة تُقدّر بقدرها، وأن لا يُستغل هذا الباب في تجارة الأعضاء أو الإضرار بالمتبرعين، وأن يكون النقل بموافقة صريحة وموثقة.
المجامع الفقهية وفتاوى العلماء المعاصرين
لم يقف الجدل عند حدود المذاهب القديمة، بل تواصل مع اجتهادات العلماء المعاصرين ومؤسسات الإفتاء.
ففي عام 1988م، أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارًا يقضي بجواز نقل الأعضاء من إنسان حي أو ميت بشروطٍ محددة، منها:
1. تحقق موت المتبرع تحققًا طبيًا لا شبهة فيه.
2. موافقته أو وصيته المسبقة.
3. عدم وجود مقابل مادي.
4. أن يكون النقل لإنقاذ حياة لا لتحسين مظهر أو رفاهية.
كما أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 1996م نقل الأعضاء وفق الضوابط الشرعية والطبية، مؤكِّدًا أن ذلك من أعمال البرّ والإحسان إذا خلت النية من الغرض المادي.
أما هيئة كبار العلماء بالسعودية فقرّرت أن التبرع بالأعضاء جائز شرعًا، سواء من حيٍّ إلى حيٍّ أو من ميتٍ إلى حيٍّ، طالما روعيت الشروط الشرعية.
الجدل الأخلاقي والإنساني.. هل الجسد ملك الفرد أم لله؟
يستند المعارضون للتبرع بالأعضاء إلى أن الإنسان لا يملك جسده ملكية مطلقة، بل هو مستخلف عليه، وأن التبرع يُعدّ تصرفًا في غير المملوك.
لكن فريق المؤيدين يردّ بأن التبرع ليس إتلافًا للجسد بل استثمار له في الخير، فكما يُشرع التصدق بالمال لإحياء النفوس، يُشرع التبرع بالعضو لإنقاذ حياة إنسان.
ويستدلون بحديث النبي ﷺ:
«من فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» (رواه مسلم).
ويرى هؤلاء أن التبرع بالأعضاء يعبّر عن أسمى درجات الإيثار، إذ يمنح الإنسان جزءًا من جسده ليمدّ حياة غيره بالأمل، وهو من أعظم صور الرحمة الإنسانية التي دعا إليها الإسلام.
التوازن بين المقاصد.. حفظ النفس أم صون الكرامة؟
تؤكد مقاصد الشريعة الإسلامية أن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة لحمايتها، وهي: الدين، النفس، العقل، النسل، والمال.
ومن هنا رأى كثير من العلماء أن نقل الأعضاء يدخل في باب حفظ النفس، متى تحققت الشروط الشرعية، وانتفت المفاسد.
لكن في الوقت ذاته، شددوا على أن كرامة الميت واجبة الصون، وأن عملية النقل يجب أن تُجرى بأقصى درجات الاحترام والسرية والتوثيق.
ولذلك فإن الموقف الفقهي العام اليوم يتجه نحو الإباحة المقيدة، أي الجواز بشروط وضوابط دقيقة تمنع الاستغلال والتجارة، وتحقق مقصد الرحمة لا المنفعة المادية.
الفتوى بين النص والمصلحة.. نحو رؤية إسلامية متوازنة
يرى علماء الأزهر وكبار الفقهاء أن الفتوى في هذا الموضوع يجب أن تراعي تطور الطب وتغير الواقع، وأن النصوص الشرعية لا تعارض العلم بل تهديه إلى المسار الأخلاقي الصحيح.
ويقول الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في أحد لقاءاته:
«إن التبرع بالأعضاء عملٌ إنساني نبيل إذا كان بقصد الإحسان، لكنه لا يجوز أن يتحول إلى سلعة أو تجارة، لأن ذلك يهدم مقاصد الشريعة».
كما أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية أن التبرع بالأعضاء يجوز شرعًا بشروط، أهمها تحقق الموت الإكلينيكي، والموافقة المسبقة، وانتفاء الضرر أو الاستغلال.

